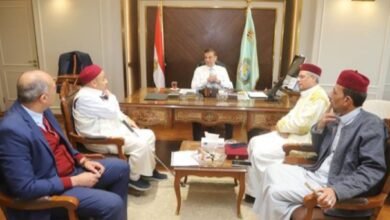فروق جوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامى
كتب : كريم أحمد
فروق جوهرية بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإسلامي
إن أي نظام إقتصادي مهما كان مسماه فهو لاشك له قواعد إقتصاديه تنبع من شخصية المستثمر والتاجر والمستهلك وما يريدون أن يحققوه من أهداف إقتصاديه تنبع من منظومة قيم حضاريه توضع عين التطبيق الإعتبار في إجراء المعاملات الإقتصاديه من بيع وشراء وإستثمار وإدخار ورهن تجاري وضمانات وتأمينات وتوكيلات إداريه وتوكيلات إستثماريه(المضاربات) وغيرها الكثير من المعاملات الإقتصاديه التي تستحدث بقدر مايستحدث من مشكلات وعوائق ويتم التعامل معها وفق قواعد ثابته يتفق عليها جميع المجتمع ضمن مايؤمن به من قيم حضارية،، وإليك عزيزي القاريء نستعرض لك النقاط الفاصلة التي توضح الإختلافات الجوهرية بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي كما يلي ،،
١-قيمة الأموال :
في النظام الرأسمالي تكتسب قيمتها من عدة عوامل وهي الندرة والمخاطرة والمنافسة والإحتكار وهي كلها عوامل ترتبط ببعضها البعض تنطلق من عامل الندرة أولا وأخيرا ،، غير أن عامل المخاطرة الإقتصاديه ينطلق من عامل العدم الذي هو أقل بكثير جدا من الندرة وعامل المنافسه ينطلق من عامل التشابه في النشاط الإقتصادي خاصة لو كان هذا التشابه غير متكامل ضمن مبدأ التخصص وتقسيم العمل فتكون المنافسة التجاريه شرسة لأبعد درجة ممكنة تؤدي إلى إنهيار الأسواق ،، والإحتكار ينتج أيضا من عامل أخر وهو العدم أيضا الذي يكون أقل بكثير من الندرة حيث ينصب الإنتاج والإستهلاك كله في شخص واحد فقط أو عائلة معينه كإحتكار عائلة آل روتشيلد اليهوديه كل مقاليد المال والصيرفه في قارة أوروبا في العصور الوسطى،، وهي كلها عوامل إذا كانت في مستوى العدم دون الندرة تؤدي لاشك إلى إنهيار الأسواق إنتاجا وإستهلاكا،، لأن الندرة لاشك حيثما وجدت فهي أقرب طريق إلى ماهو أقل منها وهو العدم فتكون الأرباح والأموال كلها تكتسب قيمتها من العدم سواء العدم من جهة الإنتاج أو من جهة الإستهلاك والذي بدوره ينتج من تفاقم عمليات الرهن التجاري التي تأتي نتيجة تفاقم الديون وفوائدها فيدخل الإقتصاد الأهلي كله في نفق الأزمه المظلم وذلك لأن الإقتصاد إنتقل من نقطة الندرة إلى نقطة العدم وبالتالي التاجر والمنتج والمستثمر كل هؤلاء يشعرون بفقدان الأمل في النهوض الإقتصادي إذا كانوا لايملكون المعرفة الكافيه بالطبيعة الماديه للموارد الإقتصاديه وماتدريه هذه الطبيعة الماديه من فوائد ومنافع إقتصاديه فيخرج الإقتصاد الأهلي من نقطة العدم إلى نقطة الوفرة والشيوع وهي أعلى بكثير من نقطة العدم والندرة ..
أما النظام الإسلامي فقيمة الأموال فيه تنطلق من عرف الناس وما يألفه الطبع البشري العام وبالتالي تصبح عوامل الندرة والوفرة والشيوع والعدم كلها ليس لها أي محل من الإعراب تماما في صياغة المعاملات الإقتصادية ،، فضلا عن أن تشكل هذا العرف يرجع إما الي عوامل تاريخيه موروثة يتخذونها كقيمة إقتصاديه وإجتماعيه على عاتقهم كإتجاه عام في الإنتاج والإستهلاك والإستثمار والرهون التجاريه والمداينات والإستعارات،،
وإما إلى العوامل الجغرافيه والمناخيه التي يتكيف معها السكان فيتم بناءا على هذا التكيف صياغة حاجاتهم الإقتصادية عرفا وتألفا في تعاملاتهم الإقتصاديه ،،
وإما إلى عوامل سياسيه من الدولة نفسها بحيث يكون قد إرتضي الناس لأنفسهم سياسة سلطان معين فألفها طبعهم فسلكوها عرفا لمعاملاتهم الإقتصاديه حيث أنه كان المسلمون على عهد السلذان الكامل الأيوبي يشترون محقرات الأشياء بعملات الحديد ويشترون بالذهب والفضة الأشياء ذو القيمة العالية وذلك فيما حكاه المقريزي أن إمرأة جائت إلي أبو طاهر المكي شيخ الجامع وسألته وقالت له : ياشيخ هل الماء حرام؟
فقال لها : وما الذي يحرم الماء يا أمة الله؟!
فقالت له : أعطيت البائع درهما أريد به قربة ماء فأعطاني قربة الماء ومعها درهما ونصف ..
فتعجب الشيخ أبو طاهر المكي من حكاية هذه المرأة وفي فجر اليوم التالي أشار على السلطان الكامل أن يسك عملات من الحديد تسمى الفلوس (جمع فلس) يشترون بها محقرات الأشياء أي الأشياء في الحجم الصغير ( قرب الماء، الزيت، الجبن، الحلوى… إلخ) ولما أعجب السلطان الكامل بهذه الفكرة أخذ يطبقها فصارت عرفا مألوفا في الناس حتى عهد المماليك والعثمانيين سوي أن المماليك والعثمانيين كتبوا عليها (الله الضامن) وعليه فصارت عرفا من ميل الطبع وتألفه ..
كما وكان علي أيام العلامة محمد بن عابدين الحنفي رضي الله عنه في أواخر الدولة العثمانيه كان الناس يتبادلون الدراهم الفضيه ببعضها بعضا مع إختلاف نسبة شوائب النحاس فيها فكان هناك دراهم عدليه ودراهم ستوقيه كانت تختلف بحسب الأوزان ويراعي إختلاف الوزن في البيع والشراء بينما يهمل الوزن في القرض إتقاءا لشبهة الربا وذلك في رسالته شذي العرف في أحكام العرف ..
٢-مفهوم الإستثمار :
مفهوم الإستثمار المربح يرتبط إرتباطا وثيقا بحجم المخاطر الإقتصاديه حيث أنه كلما زاد حجم المخاطر الإقتصاديه كلما زاد حجم الأرباح من الإستثمار ..
بينما مفهوم الإستثمار لأنه يستند إلى عرف الناس والطبع النفسي العام في الإلف فإن المستثمر سيفضل الحصول على أفضل الأرباح في أمان تام بعيدا عن المخاطر عملا بالقاعدة الفقهية درء المفاسد أولى من جلب المنافع وبالتالي سيفضل الحصول على الأرباح الجاريه الحالية بحسب عرف الناس وسوقهم ولن يفكر في الحصول على الأرباح المجهولة في المستقبل لأنها إحتمالية وتنطوي على مخاطر عاليه،، ولاحظ جيدا أنه يسعى إلى أفضل ربح وليس أعلى ربح أو أقل ربح لأن الجدوى الإقتصاديه من الإستثمار كلها تدور على عرف الناس وليس على كم معين من حيث العدم والوفرة والندرة والشيوع،، لأن في ظل العرف الكل يحقق منافعه الإستثماريه بالتساوي بعيدا عن المخاطر والمنافسات والإحتكارات..
٣-مفهوم المنفعة :
المنفعة في النظام الرأسمالي منفعة حديه ترتبط بمستويات أسعار السلع المتغيره بحسب التضخم،، وبالتالي التضخم هو مسلمة إقتصاديه لابد منها في هذا النظام سواء كان قليل النسبه أو عالي النسبة وذلك في ظل سيادة مبدأ الندرة النسبيه لآدم سميث الذي هو المحرك الأول والأخير لجميع المعاملات الإقتصاديه والذي تدور عليه رحي النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى تعظيم القيمة النهائية لرأس المال الذي هو الدخل القومي للبلاد،،
أما مفهوم المنفعة في الإقتصاد الإسلامي فهو كل مايتصف بالديمومة ويعم جميع الناس فقيرا وغنيا ومتوسطا بينهما ((فأما الزبد فيذهب جفائا وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض)) والمنافع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع الإستراتيجية مثل القمح والأرز والخبز والعسل والملح والزيت والسمك والسكر والشاي… إلخ
وهذه المنافع تلتزم الدوله علي عاتقها بتحقيق الإكتفاء الذاتي منها لما تتسم به من ديمومة النفع وعمومه على الناس،،
بينما الإقتصاد الرأسمالي لأنه يراهن على قيمة الإنسان الفردية ومواهبه الإبداعيه الجبارة في إنتاج المنافع والحصول عليها بقصد أو بغير قصد وفقا لمبدأ اليد الخفيه فإن المنافع لايضمن أبدا ديمومتها وإذا ضمن ديمومتها فقد لايحصل عليها جميع الناس إما لمنافسة شرسة أو إحتكار أو ندرة وجود أو عدم وجود،،
أما الإقتصاد الإسلامي فهو يرى أن الإنسان محدود القدرات وله منافع معينه هي وحدها الكفيلة بأن تنفعه لأنه لايستطيع أبدا أن يتحمل أكثر من وسعه مهما بذله من إبداع..